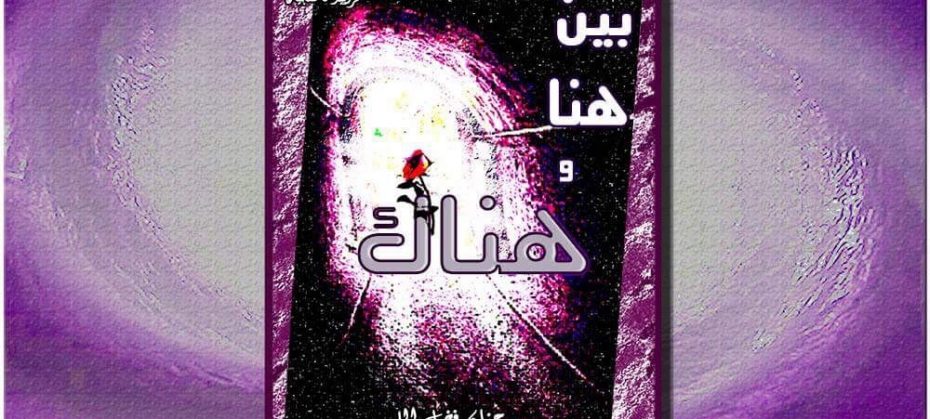..وعرفتُ أنَس
عشية بدء عامي الجامعي الأول، اجتمعنا كعائلة سعيدة.. اعتبر والداي أن هذه الليلة تستحق أن تكون عيد ميلاد لي.. فسبقا يوم مولدي الآتي بعد ثلاثة أشهر بقالب حلوى زينته شقيقتاي بثمانية عشرة شمعة.
واجتمعنا، لا غريب بيننا.. كانت أم جوزيف التي صارت صديقة العائلة، بعد أن أنجبت أمي على يديها الرشيقتين، شقيقتاي التوأم ريتا وكريستين، بعد عشر سنوات على إنجابها لي.. وكانت جارتنا تانت أم محمد وزوجها عمو أبو محمد وأولادهما الخمسة: محمد وأحمد ومصطفى وأنس وخديجة..
كنا وإياهم كعائلة واحدة.. نتقاسم إفطارات رمضان وسهرات وصباحات.. وكانوا وإيانا عائلة متحدة في صومنا الكبير وأعيادنا..
أصلاً، لم يكن فرق بين مناسباتنا ومناسباتهم.. كانوا الآخر الذي نحبّ ونتكامل به.. أو هكذا ظننت!!
ياما أعدّت لنا تانت أم محمد أطباق “القاطع” الخالية من اللحم والبياض في صومنا.. المجدرة المخبوصة، الهندباء بالزيت وعليها حبوب الرمان الحامض..
وياما حضّرت أمي المعمول لعيد الفطر أو عيد الأضحى..
مع جيراننا، حفظت فاتحة القرآن الكريم عن ظهر قلب، وكان أولاد أم محمد يحفظون الأبانا والسلام ويضيئون الشموع لأمنا مريم.. علمتهم الأبانا والسلام عليك يا مريم على اللوح الخشبي.. كنت في صغري أرغب أن أصبح معلمة، مدرّسة، مربية أجيال مثل أبي.
كانت سهرة عيد ميلادي تلك، آخر ليلة أقضيها بلا قلق ولا أرق.. فكل أيامي كانت رتيبة وفارغة من أي هم.. حتى أنني أذكر أنني ابتهلت إلى الله أن يشغل بالي.. فانشغل ولم يهدأ حتى اللحظة.
قطعنا قالب كاتو من إعداد أمي، بعد عشاء لذيذ من يدي أم محمد وأمي أيضاً، جيران الرضا ونحن..
كانت سعادة أمي أكبر من أن توصف..
“روز صارت صبية”.. هي أنا.. فخر أمي وأبي.. أنا روز الجميلة، المرتبة، وحسنة التربية.
بعد تلك الليلة، انقلبت حياتي وصار أنسي أنسان وحياتي حياتان.. قبل وبعد..
أراني صبيحة اليوم التالي، استيقظ بكل حماستي باكراً جداً، لأحتفل بكل ثانية من أول يوم لي في الجامعة..
![]()
أول يوم من عمري الجديد..
الجامعة هي أنسنا الآخر.. هي تنفس صعداء وشعور طاغٍ بأننا كائنات مستقلة.. نمشي بخفة وثقة أكثر.. نتباهى أكثر.. نحن عنوان التحرّر.
أراني واقفة أمام المرآة، مع ابتسامتي العريضة التي لونّتها بأحمر شفاه زهري خفيف، أهدتني إياه أمي.. بالكاد يظهر..
أسرّح شعري البني الطويل والجميل.. ثم أعقده إلى الخلف بشريط زهري لطيف.. وأرتدي فستاني الكحلي الجديد، بكميه القصيرين، المزيّن بورود زهرية دقيقة.. أزرّره جيداً حتى آخر فتحة تحت الركبتين.. وأنتعل حذائي الجديد الخفيف ثم أعود إلى المرآة لأطمئن على شكلي.. لا بأس بي.. لا بأس أبداً.. أبدو جميلة وأنيقة ومشرقة..
في الجامعة، يمكن لي أن أرش عطراً خفيفاً على شعري وفستاني.. هي عادة اقتبستها من أمي.. أمي ترشّ العطر في شعرها.. وحين تمرّ.. في أي وقت تمرّ.. تفوح رائحتها.. هويتها..
خرجت من غرفتي، تفوح هويتي مني.. وتوجهت إلى طاولة الطعام التي رتبتها أمي في مطبخنا الكبير..
كانوا جميعاً هناك.. يتناولون الفطور.. ومكاني جاهز، كما العادة، وإبريق الشاي جاهز، مع الخبز المحمص والجبن واللبنة والزيتون الذي كبسته جدتي، وساعدتها في قطافه..
كان آخر موسم زيتون لجدتي.. قبل أن تموت..
نامت في فراشها، بعد يوم عمل طويل.. كبست “الزيتونات” ثم رتبت البيت.. وجهّزت فناجين القهوة العربية.. دزينتان من الفناجين، وركوة قهوة عملاقة، وضعتها على صينية فضية كبيرة، لمعتها بالرمل وقشر الحامض، رتبت الكراسي بشكل مريح لكثير من الزوّار.. ثم استحمّت ومشطت شعرها الرمادي، وارتدت أحلى ما عندها.. فستان أبيض من الدانتيل المبطن.. وآوت إلى فراشها.. لم تقفل باب بيتها تلك الليلة..
ماتت جدتي في سريرها.. حين بقيت يومين في فراشها، قبل أن يحين موعد زيارتنا لها..
أذكر أن صبيحة ذلك اليوم، استيقظت على وجه جدتي يبتسم لي، ويدها تلوّح لي مودّعة.. جلست في السرير وأنا أضع يدي على قلبي.. خبّرت أمي عن الحلم.. فقالت لأبي:
– ألبير.. لازم نروح عند أمي.. أكيد صاير معا شي..
رحلت جدتي.. وبقيت أبكيها طويلاً.. حتى آخر الزيتونات لم يأكل أحدٌ منا، حبة واحدة منها..
ومع أن جدتي كانت تردد:
-كل شي أحسن من بني آدم..
إلا أنني بقيت طويلاً أرفض ذلك وأردّد أن جدتي أحسن من كل شيء.. من الخضار والثمار والأشجار والزيتون.. ما نفع الزيتون من دون جدتي.. ما نفع الزعتر من غير ابتسامتها.. ما نفع الأرض والزرع وبيتها الجبيلي الجميل من دون نفَسِها يتردّد في زاوياه؟
وتأكّدت بعدها، أن الغياب يحضر الذاكرة الطيبة.. والذاكرة الطيبة يصنعها الفعل الطيب بالنية الطيبة.. وأقسم أن نيتي في كل ما فعلت كانت طيبة..
وأعود إلى صباحي الجامعي الأول.. تناولت القليل من منقوشة الزعتر الساخنة الطازجة الشهية التي حضّرتها أمي..
أمي سيدة عظيمة في إدارة أمور البيت.. لم تنم ليلة أمس قبل أن تنهي كل التنظيفات اللازمة التي تسبب بها عزيمة الليلة الماضية.. وتحضّر العجين لتخبز مناقيش الصباح.. عرضت أن أساعدها لكنها رفضت.. فأنا غداً سأكون تلميذة جامعية.
-“معقول تلميذة الجامعة الحلوة القمورة المرتبة، تحشّي أضافيرا عجين”؟ مازحتني أمي.. كم كانت فرحة بي..
استقبلني الجميع بابتسامات كأنهم يرونني للمرة الأولى.. كان شكلي جديداً عليهم..
كنت في عيني شقيقتيّ سندريللا الحكاية.. وفي عيني أمي حلماً تحقق.. أما أبي فكان فخوراً بي.. جداً.. أنا امتداده..
أنا بالذات..
سأنهي اختصاصي في اللغة الانكليزية وسأصبح معلمة مثله.. ومكاني محفوظ في المدرسة التي يرأس فيها قسم اللغة الإنكليزية.. مرتاح أبي.. عيناه الباسمتان خلف نظارتيه تقولان ذلك.. خطته في تأمين مستقبلي تمشي كما رسم..
وكان لا بد من توصيات:
ألاّ أحادث الغرباء.
ألا أردّ بالابتسامة على ابتسامة أحد.
ألاّ أسمح للشبان بملاطفتي وأن لا أتحرك من مكاني إن اشتغل القصف والتقاذف..
في تلك الفترة كان البلد حائراً بين لا سلم ولا حرب.. تعوّدنا الحال على ما هو عليه حتى صار هذا، جزءاً من يومياتنا.. لم تعنِ لي الحرب كثيراً.. وكأنني لا أريد أن أعترف بها.. أو ربما لأنني لم أكن على تماس بها، لا أنا ولا أي من عائلتي.. أبي لم يكن يؤمن بالأحزاب، كان يؤمن بالوطن، جامع الكل وأبي الكل.. وأنه ذات يوم سيرمي المتقاتلون أسلحتهم، ويتبادلون القبلات.. لن يكون وقت للوّم حتى.. سيبني الجميع ما تهدّم.. لأنه في النهاية لا يمكن لأحد من أبناء البلد أن يعيش من دون الآخر.. والآخر هو قطعة “البازل” التي تكمّل لوحة البلد.
لم يكن أبي على حق.. لقد خدعه الجميع.. وشيئاً فشيئاً، بصمت مريب.. صار واحداً من هؤلاء المبتاعدين المتباغضين..
الآن أعرف أنهم كانوا جميعاً ضحايا على حق.. وكانوا جميعاً قتلة..
لقد تظهرت جينة كُره الآخر بأبشع صورة.. رفض الآخر لأنه مختلف.
ولكن، مع كل استعار الحرب وتنوّع وقودها، من ناس ومصالح، وأحزاب، ودول وأطراف.. كانت بعض زوايا أمل منيرة بالحب، مفعمة بالفرح، ضاجة بالأمل وتنمو، وتعقد لها مواعيد مع من قرروا أن يحبّوا بصدق، ويقاوموا الحزن الطويل والبغض الكثير.. وغالباً ما دفعوا الثمن. كان قوة حياة تواجه القتل والإلغاء والتدمير.. كنا أجمل من الموت اليومي الذي كان.
تناولت القليل من الطعام، قطعة من المنقوشة المقرمشة الشهية.. مع القليل من الشاي.. واكتفيت..
“الحمدلله.. ادعولي” قلتها على عجل.. وسط تفهّم أهلي لانبهاري بيومي العظيم هذا.. وسارعت إلى المرآة فوق المغسلة، لأطمئن إلى عدم وجود فرمة زعتر على أسناني أو بينها.. وأغسل يدي وفمي جيداً، وأعيد وضع بعض زهريّ الشفاه.. ضحك أبي ولمعت عيناه بطيف دمع.. وكذلك أمي.. يا لهذا الاحتفال الطيب بنضوجي.
خرجت من البيت أتأبط “دفاتر الجامعة”.. يرافقني صوت أمي المتمتم لي بصلاة رفعتها إلى الله والسيدة العذراء كحماية لي من كل عين وكل سوء وكل شر، في ذهأبي وغيابي وإيابي..
أعطاني والدي مصروفي الشهري بالأمس ومعه عيدية.. وها هو يضيف إليه مبلغاً إكرامية كي أشتري ما يحلو لي من كافيتيريا الجامعة..
لا أعرف ما الرابط بين النضوج وكافيتيريا الجامعة.. هل هي المكان الذي يؤكد استقلاليتنا عن وصاية أهلنا؟
هل طاولاتها الخشبية وكراسيها البالية من كثرة الاستعمال، هي الحصص اللازمة لترفّعنا من رتبة تلميذ مدرسة الى طالب جامعي؟
هل ضيق مساحاتها أوسع من مدى ملاعب أيامنا السابقة؟
هل جدرانها العابقة بدخان سجائر الطلاب في تدخينهم العلني، أنقى من شرفات بيوتنا؟
هل هكذا نراها؟
..وأخرج إلى زمني الجديد.. أتلذذ بالهواء الطري الذي يداعب وجهي.. لقد عبرت هذه الطريق مراراً.. لكن لهذه المرة طعم وعد مختلف.
سأسلكه كل يوم وأعتاد عليه.. سأحفظه عن ظهر قلب. سأمر بشجرة اليايسمين المعمرة هذه.. ثم بدكان أبو سامي ثم أعبر إلى الجهة المقابلة ثم أدخل في مفرق ضيق طويل وأشاهد هذه السيدة التي تجلس مع زوجها على بلكونتها الأرضية خلف شتولها، تشرب قهوة الصباح معه.
سأعبر طريقاً ضيقة ثم أصل إلى الجامعة..
وفكّرت.. خلال هذه السنة الدراسية، قد التقي بأمير أحلامي.. لا ربيع ابن عمتي جورجيت الذي كنت سأنتظر قدومه إلى بيروت ليأخذني عروساً له.. كان هذا خيار العائلة بشقّيها المهاجر والمقيم..
هذا كان اتفاق أمي وعمتي الوحيدة التي لم أعرفها شخصياً، فقد هاجرت مع عائلتها إلى استراليا أول الحرب واقسمت أنها لن تعود إلى لبنان، إلا حين يصبح البلد بلداً يحمي أبناءه من الغربة.. لم تعد عمتي جورجيت إلى لبنان، ماتت في غربتها بعد أن غزا جسمها السرطان.. ولم يحم البلد أبناءه من داء الغربة.. لكنها كانت ترغب في أن تبقى الصلة بينها وبين أبي وبين الوطن من خلالنا.. ربيع وأنا..
مرة، خصّني ربيع برسالة كتبها بالانكليزية اخبرني فيها انه يحبني كما يحب اخته باتريسيا ورجاني أن ابادر انا إلى رفض الزواج منه. ربيع لا يجرؤ على ردّ طلب والدته المريضة، لكنه لا، جزم لي، ليس مستعداً لقضاء حياته مع بنت لا يعرفها إلا من خلال الصورة وإيحاءات الأهل.. لا يوافق على أن يتفق الأهل على أولادهم.. هو صادق في مشاعره، لم يعرفني إلا من خلال الصور التي كانت ترسلها أمي إلى عمتي وتكتب على قفاها: “وهاي روز الحلوة”!!
قال في رسالته إني جميلة جداً ولطيفة، لكن لن يضحي بحبه لـ ليندسي زميلته في الجامعة، لأي سبب من الأسباب”.
تفهمت موقف ربيع طبعاً.. كيف يكون الإنسان شريك عمر لم يختره قلبه؟ كان ربيع يحكي أفكاري.. ومثله أنا.. أريد أن أحب وأدافع عن حبي.. أريد حباً يواجه العواصف، والأعاصير إن هبّت.. أريد رومانسية تذيبني، تخدّر أطرافي.. تنمّل قلبي.. أريد أن يجرني قلبي من عينيّ ومن أذنيّ ومن شعري إلى حيث اختار.. أريد فتى كل الحكايات التي قرأتها ثم تشكّلت تفاصيل في أحلام نومي ويقظتي ايضاً.
كتبت لربيع ابن عمتي رسالة، شرحت له فيها موقفي:
“وأنا أيضاً أحبك مثل أخي يا ربيع لا تقلق، في الوقت المناسب سأتصرف كما يجب.. بلّغ ليندسي تحياتي.”
لم أكن أعرف أن أمي وأبي وعمتي جورجيت وزوجها علموا جميعاً بمكاتباتنا، ربيع وأنا.. وأنهم تفهموا مرغمين مشاعر الأخوة التي تبادلنا الإقرار بها عن بعد. لم نلتقِ أنا وربيع أبداً، إلا في الصور، وانقطعت المراسلات بيننا..
ولاحقاً فهمت أن تلويح والدي لي بزواجي من ربيع، لم يكن سوى استباق داهية، لعاطفة قد تتفتّح مع غريب.. غريب!!
كيف عرفا أن قلبي ومشاعري وعاطفتي وكلّي.. لن نتفتّح إلاّ لغريب..
![]()
وأخيراً وصلت إلى جامعتي..
صار قلبي يخفق بسرعة حتى كاد ينخلع من صدري.. هنا عالمي الجميل الذي سأقصده كل يوم..
أراني أتقدّم ببطء.. أحاول أن أكمش ابتسامتي التي تمدّدت كي لا يلاحظ أحد انبهاري..
وأستكشف..
شبان وصبايا يصلون أو وصلوا قبلي.. يضجّون بالحياة وبالثرثرات، مجموعات وأفراداً، سأجد بالتأكيد صداقات.. خصوصاً وأنني أمضيت مراهقتي وطفولتي من دون صديقات.. فأولاد جيران الرضا، كانوا صبياناً صغاراً.. وخديجة كانت صغيرة جداً جداً.. كنت كبيرة المجموعة.. كان عالمي محدوداً وكنت مكتفية به..
هنا ستتفتح حياتي وأمنياتي وأحلامي وستتوسّع دائرة صداقاتي أكثر.. ستكون لي صحبة مع فتيات من عمري، أكبر قليلاً، أصغر قليلاً لا يهم..
وها أنا الآن.. أراني التفت الى الناحية الأخرى واتابع استكشافي.
مبنيان متقابلان، يفصلهما ممرّ عريض على اليمين مدخل قسم الآداب، ثم مدخل آخر كتب عليه الإدارة يطل، وينتهي البناء بكافيتيريا “أبو هاني”، يعرف عنها لوحٌ معدني طاله الصدأ.
وأنقل نظري إلى الناحية الأخرى، لأعاين المبنى المقابل.. فأراه، أرى أنَس.. وينخطف نفَسي..
مشغول بالتحدّث إلى صديق له.. إنه خليط من وسامة عمر الشريف ورشدي أباظة وإيهاب نافع.. كنت مغرمة بهم، وبلهجتهم، وبعيونهم وبقاماتهم وابتساماتهم.. هو مثلهم.. لكنه ليس بالأبيض والأسود.. كنت أتسمّر أمام شاشة التلفزيون مع موعد عرض “الفيلم العربي”..
والتفتَ إليّ. انتبه لي.. ثم سكت وحدّق بي.. أرى في عينيه كيف رأتني عيناه.. جمعٌ رقيق من فاتن حمامة وماجدة الصباحي ومريم فخر الدين.. وهذا ما قاله لي لاحقاً..
شعرتُ بسخونة شديدة في قلبي.. جمر مشتعل ينتشر في كلّي..
لا أعرف كم بقينا من الوقت نتأمل بعضنا البعض، علنا كنا نتبادل عهود الحب الكبير الذي جمع بيننا، منذ تلك النظرة.
ترك أنَس صديقه واقترب مني.. تمنيت لو أنه بقي ينظر الي.. صار قلبي يخفق بسرعة.. وأجدني لا أحتمل أن يقترب مني, ليتني أتبخر.. أذوب.. أتناثر.. أختفي.
-“صباح الخير”. قالها وهو يبتسم كأجمل ما حلمت.. كان بهياً لطيفاً أنيقاً عطراً..
لاحظت أنه يرتدي قميصاً أبيض اللون، مقلماً بخطوط زهرية رفيعة وبنطلونا كحلياً.. مثل ألوان ثيابي.. وتفاءلت.
– “أنا قلت صباح الخير..- كرّر وأضاف- ده أول يوم ليكي في الجامعة؟!
سمعته سمعته لكن اختنق صوتي.. ياه ما أجمل صوته.
– انتِ اختصاص ايه؟ سأل..
-“إنت مصري”؟ يا لخيبتي.. فرّ السؤال مني دون تفكير، لم أستطعه سحبه ولا ردّه..
ضحك أنَس مستظرفاً سؤالي.. وظل ينظر في عيني دهراً ويبتسم..
استلطفت انعدام شعوري بالوقت، والدفء الغريب الذي أشعر به..
هكذا التقينا أنَس وأنا.. هكذا ولد حبنا.
أنَس الذي خبّرني أن قدره قاده إلى هنا هذا الصباح، أنَس الذي أحبني كما لم يحب أحد أحداً.. أنَس الذي فقدني، كما لم يفقد أحدٌ أحداً..
أنَس الذي طويت معه صفحة حياتي وفتحت مجلداً من الحب والعذاب معاً..
بعد النظرة الأولى.. لم نفترق إلا يومَي السبت والأحد والعطلات الرسمية..
كان أنَس يأتي خصيصاً ليراني عند الصباح، ثم يعود ويصطحبني إلى المفرق القريب من بيتنا عند انتهاء المحاضرات.. جدولنا وقتنا جيداً.. ونظمناه، مع ذلك، لم أقصّر في دراستي ولا أنَس قصّر..
كان أنَس في سنته الجامعية الرابعة ينهي اختصاص إدارة الأعمال في الجامعة العربية.. ولأن بيروت مدينة طلاب العلم.. فقد اختار والده اختصاصه، كي يستلم أعماله ويساعده في إدارة شركاته بعد أن يتخرّج..
كان أنَس مؤدباً مهذباً لائقاً.. جمعتنا أغنيات فيروز المنسابة صباحاً من مقهى أبو هاني حيث كنا نلتقي.. أدّبت حبنا وأبقته نظيفاً.
أحببت أنَس وأحببت مصر وأهلها.. “مصر أحلى من الأفلام حتى”.. خبرني عن صباحاتها وعن نيلها وأهرامها.. وعن ليلها الثرثار، وعن أريافها وناسها الطيبين..
تفاخرت بوالدي المتآخيين مع جيراننا، حتى أنني اعترفت له أنني كنت أظن أن جيراننا “مسيحية إسلام”.. وأخبرته أن في مكتبة أبي الكبيرة كتاب القرآن الكريم، وسيرة النبي محمد وعلّمني كيف أُتبع اسم الرسول الكريم بـ “عليه الصلاة والسلام”..
أنهيتُ عامي الأول بسعادة حب ممتاز، ونجاح بدرجة جيد جداً. سُرّ بي أنَس، وازداد حباً بي.. قرّر أن يختار اختصاصاً جامعياً آخر، كي يبقى بالقرب مني.. ثم تخصّص في حبي..
![]()
دعاني أنَس لنحتفل.. لم أحتر ماذا أقول لوالديّ.. نجاحي يستحق أن أغيب لبضع ساعات من البيت، وأخترع كذبة بيضاء:
-رايحين عا كافيتريا الجامعة أنا ورفقاتي”. من قال إن الحب لا يعّلم الكذب، ريثما يقوى عودُه؟
حجز أنَس قاعة في أحد أفخر المطاعم، واستقدم عازف كمان ليسمّعني موسيقى رائعة محمد عبد الوهاب “كان أجمل يوم”..
دعاني إلى رقصة رومانسية.. والشموع تضيء المكان الذي طلب تعتيمه.. لبّيت دعوته.. حفر صورته في بؤبؤ عيني.. أرخيت رأسي على صدره واستسلمت لدفء سعادة لذيذ..
أليست هنا، بالقرب من نبض قلب من نحب، تعشش سعادتنا.. بلى.
سهرنا أنَس وأنا، لوحدنا.. من قال إن السهر لا يكون في وضح النهار ويمتدّ إلى ما بعد الظهر؟
وأهداني سلسلة ذهبية عليها أيقونة للسيدة العذراء وآية الكرسي.. أعجبت أمي بهدية “رفقاتي”، ما أعلى درجة وعيهم؟ ياه!! كم كان صعباً عليّ أن أخفي حبي له عن أمي.. وعن أبي.. كان صعباً جداً.. إلاّ أنني نجحت..
كنت كلما تحدثت مع أبي في سهراتنا، أبعد عيني عنه.. كي لا يرى أنَس فيهما.. كنت إذا صبّحت أمي، أضم يديّ إلى صدري كي لا تخرج صورة أنَس منه..
كنت كلما حكيت لشقيقتي حكايات ما قبل النوم، سمّيت بطل الحكاية أنَس، وأُسمّي البطلة وردة، زهرة، فلاور.. كل مرادفات إسمي.. كنت أميرة أنَس في كل الحكايات.
وبوجود أنَس، لم أكن بحاجة إلى صديقات أو شلة وزميلات أو صحبة بنات..
وحدها سالي عَرفت وباركت وشجعت.. كانت تكبرني بعشرة أعوام وسنتين دراسيتين.. دخلت قاعة الصف ذات يوم تسأل عن هدى ونجوى الشقيقتين، كانتا جارتَي مقعدي، وتعارفنا..
لم تكسرها الحياة بل حوّلتها إلى ماكينة تحقيق أمنيات وضخّ تفاؤل..
وحين زارتنا في بيتنا أحبها أهلي كثيراً خصوصاً أبي وجدها شابة مكافحة، مثقفة، ذكية وبارك صداقتنا.. كذلك أمي.. شعرت أنني مع سالي، سأكون بأمان.
لم تتوقف سالي عن مجابهة الصعاب بشجاعة عالية.. توفيت والدتها برصاص قناص وأصيب والدها بشلل نصفي، أقعده عن كل شيء إلاّ الدعاء لابنتيه..
عملت سالي في التمريض وفي التعليم الخصوصي وفي إدارة بيت فيه، والدها وشقيقتها الصغرى، إلى أن زوجتها من مهندس، حملها وسافر بها الى الإمارات..
بعد وفاة والدها، حملت رضاه في آخر كلمات لفظها، ذخيرة لكل عمرها وشهادة تقدير، وقررت أن تتابع تحصيلها العلمي إلى جانب إدراتها لمركز حققت فيه حلمها الكبير، بمساعدة النساء المتروكات المقهورات المعذبات.. مثل أم هدى ونجوى، واختارت أن تتابع دراستها في علم النفس، وشجعتني على دراسته إلى جانب الأدب الانكليزي في العام المقبل.. لا الأنس ولا الوقت يقفان عائقاً أمام ما نريد، والأهم أن نريد.
لاحظت سالي ما بيني وبين أنَس، باركت اختلاف الدين بيننا واعتبرت أنه غنى وترجمة فعلية لعقلية بيتنا المنفتحة. حتى أن أمي أقامت مأدبة إفطار على شرف “جارة الرضا” وعائلتها ودعت سالي ضيفة هذا الشرف..
في اليوم التالي، ظلت سالي تحكي لأنَس عن أجواء الإلفة في بيتنا حيث التعايش في أحلى صوره.. “نحنا ما عنا مسلم مسيحي.. أخلاقو هي دينو لأي إنسان بيفوت بيتنا وبيصير منا”.. هكذا ردّد أبي ووافقته أمي مؤكدة: “وكيف لكن!”.
لم أعرف ما هو دين سالي، ولم يخطر ببالي أن أسألها.. سالي التي تشعّ خيراً ووداّ ومحبة.. دينها أخلاقها، والمعاملة الحسنة بين البشر.. هي الطريق إلى الله.
ما أسعد ايامي وأحلاها.. وحولي أناس متفهمون، متحابون، وحان الوقت كي نكمّل أحلام أهلنا فينا، وأن نتوّج علاقتنا التي تتعمق يوماً بعد يوم، أنَس وأنا، بأن نعلنها لأهلي..
أخبرنا سالي بالأمر.. فبرقت عيناها وعدّلت في الاقتراح الذي قدّمه أنَس: أن يدعو عائلتي بحضورها، فتكون جلسة تعارف تمهّد لزيارة لاحقة الى بيتنا.. وفضّلت سالي أن تدعونا جميعاً إلى بيتها وتقيم على نية نجاحي، حفل عشاء “فيه كل الناس الطيبين.. أهلك وجيران الرضا، وأنَس وبعدين بس تروحي عالبيت بتفاتحيهن بالموضوع”..
أحب أنَس الفكرة وأنا أيضاً..
لن يصعُب على سالي أن تقيم مأدبة عامرة فاخرة.. كان العشاء وهمروجته، هدية من سالي لنا، أنَس وأنا..
هي تعيش وحدها وستحضّر كل شيء على أكمل وجه..
-ما تعتلوا همّ شي.. أحلى عشا ورح بيضلكن وجّكن.. انتو حددوا الوقت بس..
سندعو فوزي صديق أنَس وزميل دراسته وندعو أيضاً نجوى وهدى زميلتا صفي.. نكون مجموعة، ونهيىء الجوّ للتعارف بين أنَس وبين والديّ..
أرادت سالي أن يكون اللقاء عائلياً لطيفاً بامتياز، وحضرت لتجمع أهلي بأنَس في بيئة ودية.
زارتنا سالي في البيت ودعت أبي وأمي وأنا وشقيقتيّ وجيراننا أيضاً الى بيتها..
كبرت سالي أكثر في عيني أمي وأبي..
-“شو بنت أصول؟ حبيبة قلبي سالي”.. قالت أمي وهي تعبر عن إعجابها الكبير بلياقة صديقتي..
أما أبي، فقد شعر بفخر إضافي من اختياري.. وتعزّزت ثقته بي في أنني عرفت كيف أنتقي أعزّ صديقة لي وللعائلة.
أراني الآن في غاية السعادة والتوتر معاً.. سألتقي بأنس، وأنَس سيلتقي بأهلي.. نحن على الطريق الصحيح..
قاد أبي السيارة بنا، أمي، شقيقتي وأنا، وخلفنا أبو محمد وعائلته، إلى حيث أرشدتنا سالي.. منطقة عين المريسة قبالة البحر مباشرة..
بيت قديم جميل وحميم.. أحببت كل ما فيه.. بابه الحديدي المطليّ باللون الأخضر ومنه إلى الدرج الذي يوصل إلى الشرفة الكبيرة المطلة على البحر ومنها إلى باقي البيت.
لم أكن زرت بيت سالي من قبل لم أتوقعه بهذا الجمال هو من طبقتين.. غرفة كبيرة جداً تحت، قسمتهما سالي بطريقة رائعة، وغرف فوق جعلتها عالمها الراقي..
ما ورثته عن أبيها ستحوله في ما بعد إلى مركز لجمعيتها الموعودة.
بهرني بيت سالي.. ديكور ذكي استفاد من كل المساحة: ركن استقبال إلى اليسار وإلى اليمين خُصص للطعام تتوسطهما، في العمق، غرفة للجلوس وطاولة مكتب لسالي خلفه مكتبة غنية وصور والديها وشقيقتها وعريسها تزين الجدار.. ثم مطبخ يؤدي إلى حديقة خلفية..
استقبلتنا سالي ومعها نجوى وهدى اللتان ساعدتاها في إعداد العشاء..
كان كل شيء جاهزاً على الطاولة الطعام الكبيرة.. حفل عشاء حقيقي..
وصول أنَس يرافقه فوزي زاد ارتباكي وقد لاحظت استغراباً في عيني أمي..
دخل أنَس وبيده باقتا ورد صغيرة قدمها لسالي وكبيرة قدمها لي.. إضافة إلى قالب حلوى كبير حمله فوزي. حيا أنَس الجميع وحين وصل الدور اليّ شدّ كثيراً على يدي. كان سعيداً وكنت مثله.. وكانت عينا أمي تراقب.. خلف ابتساماتها أسئلة كثيرة.
بعد انتهاء العشاء جلس أبي وأبو محمد وأنَس وفوزي في الصالون يتحدثون.. الأولاد جهزت لهم سالي كتباً في غرفة جلوس الطابق العلوي.. بينما جلست أمي وأم محمد وهدى ونجوى وسالي وأنا في غرفة الجلوس.
لم أتجرأ على اختيار مكان يكون مقابلاً لأَنَس.. يكفي أنني كدت أوقع بعض العصير على الأرض.. جلس أنَس قبالة أمي التي صارت نظراتها تقيسه بالطول وبالعرض، من فوق إلى تحت، ثم تسرح بأفكار مبهمة..
هربت إلى المطبخ لأعدّ القهوة وأخفف من لهيب وجهي الذي اشتعل احمراراً وأسئلة قلقة: هل تكون أمي لاحظت شيئاً؟ لِمَ تنظر إلى أنَس هكذا ثم إلى سالي ثم اليّ ثم إلى الأرض؟ هل شعرت بما اتفقنا عليه؟ هل أحسّت بما بيني وبين أنَس؟
حضّرت الفناجين وصببت القهوة وحملتها إلى الصالون لأبدأ بتوزيعها بالدور.. على الرجال أولاً.. أبي، أبو محمد، فوزي ثم جاء دور أنَس .. والصينية لا تزال مملوءة بالفناجين.
بدأت يداي ترتجفان.
أنقذني تدخّل سالي من فضيحة ارتجاف يدي.. وقبل أن تنسكب القهوة بفعل الاهتزاز، كانت يداها بالمرصاد.. أنقذتاني من افتضاح حبي لأنَس وربما انكشاف تخطيطنا لهذه السهرة..
أمي ليست غبية.. عيناها تقدحان تحليلاً..
-“هاتي عنك.. أخدني الحديث.. تركتك تعملي القهوة فهمنا.. بس تقدميها كمان؟ وانت صاحبة المناسبة؟ كتير هيك ما هيك؟”
ضحك الجميع إلا أمي التي ارتسمت على حاجبيها إشارات الاستفهام، حتى أنها لم تبتسم!
في طريق العودة، غمرت الباقة التي أهداني إياها أنَس. كنت أريدها أن تحميني من شرٍّ آتٍ؟
لم تقل أمي كلمة واحدة.. ظلت تنظر عبر شباك السيارة وهي تسمع المديح الذي يكيله أبي عن سالي وأن علينا في أقرب فرصة، نردّ احتفالها بي باحتفال أجمل، وندعو جميع من حضر الليلة.
حتى عندما ودّعنا جيراننا وذهبوا إلى بيتهم، متمنين لي عاماً جامعياً جديداً وسعيداً مع إضافة “عقبال فرحتك الكبيرة”، سايرتهم أمي بابتسامة بالكاد رسمتها على شفتيها متذرعة حين سألتها أم محمد عما بها، بـ “راسي عم يوجعني شوي”..
سارعت إلى غرفتي وأنا أحمل باقة الورد الكبيرة الملوّنة التي أهداني إياها أنَس.. كنت كأنني أحضنه.. أمي كانت ترى كل شيء.. الآن أعرف أنها كانت ترى كل شيء وتولد في صدرها الشكوك..
احترت في أمري تلك الليلة.. هل أستعيد نظرات أنَس وحرارة يده في يدي ونظراته الدافئة؟ أم أقلق من تصرفات أمي ونظرات أمي وما وراء عيني أمي؟
-“شو هالسالي؟ شو قديرة.. وللا أنَس يا عيني على هالشب شو خواجة؟” قال أبي، فردت أمي قاطعة استرساله: “تحكيني شوي ألبير؟”
حتى وقت متأخر من الليل كان حديث غير مفهوم يدور بينهما، تديره أمي، انتقلا به من الصالون إلى غرفة النوم..
كنت أنا كلّ الموضوع.
![]()
صبيحة اليوم التالي، أفقت مزعوجة، لم يغادرني قلق الليل الذي طال.. قلبي مقبوض، ورأسي يؤلمني.
كيف سيكون وجه أمي هذا الصباح؟ هل ستسألني عن أنَس. لم يعجبها أنَس؟ لم لا يعجبها ما الذي أزعجها في السهرة؟ لماذا كتم أبي مديحه لأنَس؟
وأصعب ما واجهني خلال أرقي هو أن العطلة الصيفية بدأت، وستبعدني عن أنَس.
توجهت إلى الشرفة حيث أمي وأبي يشربان قهوة الصباح.. ويستمعان إلى أخبار الراديو. وقد غادرهما للتوّ جيران الرضا.. على غير عادة.
حييتهما وجلست.
-“صباح النور”.. رد أبي دون أن ينظر اليّ، بل بقي يركز يتأمل جهاز الراديو كأنه يرى المذيع الذي يقدم نشرة الأخبار.
أين ذهب حماس الأمس؟
-“صباح النور” ردت أمي أيضاً وفاجأتني بسؤالها اللطيف “صبلك قهوة”؟
احترت في ما أجيبها، وقد لاحظت فنجاناً ثالثاً على الصينية، هل أقول لها نعم أم لا؟
اكتفيت بالقول: “متل ما بدك”.. خجلت من أمي ومن وجود أبي، في أن أمسك فنجان قهوة!!
هذه هي المرة الأولى التي تدعوني فيها إلى شرب القهوة، بالنسبة لنا عيب على البنات أن يشربن قهوة “بعد بكير”..
قبل الزواج لا تشرب الفتيات الصغيرات القهوة.. بعد الزواج الأمر عادي ومقبول..
أمي مثلاً، شربت القهوة مع أبي خلال شهر العسل.. دلق لها السكر في الفنجان حتى ابتلعتها، ومن يومها وهي تحب القهوة الحلوة.. حصانة أمي كانت في أبي هو من علمها أيضاً على التدخين، وكان ولا يزال، يستمتع بالجلوس معها هنا، على هاتين الكرسيين، فتسايره بسيجارة صباحاً وواحد بعد الغداء وثالثة بعد العشاء.
صبّت لي فنجان قهوة، ثم وضعت فيه ملعقة سكر.. وحرّكت طويلاً طويلاً.. هل نوع السكر جديد ولا يذوب في القهوة الساخنة بسهولة.. طبعاً لا.. أمي تحضر لي أمراً ما..
-“خلص هلق صرتي صبية.. سنة تانية جامعة”.. قالت أمي وفي كلامها كلام آخر؟
قرّبت الفنجان إلى فمي بحذر.. كنت أحب رائحة قهوة أمي.. لكني لم أحب طعمها.
حتى أنَس لم يشجعني على شرب القهوة، في بيتهم أيضاً، تقول الأصول إن البنات الشابات العازبات، لا يشربن القهوة..
صبّت أمي لنفسها فنجاناً آخر.. وزادت على فنجان أبي الذي لا يزال يصغي إلى نشرة الأخبار.. كرهت السياسة ولم أفهمها.. لم أفهم كيف تكون سبباً للموت، ثم وسيلة للتصالح.. كيف أنها فن الممكن وهي في الأساس فن اللامعقول واللامقبول واللاممكن؟
أصلاً.. لا عدو بيننا نخاف منه، ولا خصم لنا لا نأمن جانبه..
كنا من العائلات المسيحية القليلة التي قررت أن تبقى في “الغربية”.. لقد رفض والدي الفرز الطائفي، فلم يغادر بيته ولا انقلع من جذوره.. حتى عندما سألته عمتي الرحيل معها إلى استراليا.. رفض “لما بتجي ساعتي بموت لو كنت بفرشتي”.. ليته مات في فراشه!!
كنا مستقرين، أبي يعمل ويتقاضى راتبه آخر الشهر وحين يتأزم الوضع الأمني نبقى في غرفنا.. بيتنا كان آمناً.. منطقتنا لم تفقد نبض حياتها..
أنا كرهت الحرب فهي سبب ظهور وحش التعصّب الكامن فيهم.. فيهم كلهم.. أنا لا.. أنَس لا.. سالي لا.. ومن بعدنا روزا لا.. طارق لا.. ومثلنا كثُر.. لا أريد أن أعرف العدد.. لكنه كاف ليقول لا..
قطعت أمي كل أفكاري بأن قالت ما خربط كل كياني: “مش قليلة هالسالي”!!
إنها سالي إذن ليس أنَس من أزعج أمي.. ارتحت واسترخيت على الكرسي..
-“ليه ماما؟” سألتُها وكنت فعلاً أريد جواباً شافياً على ما لم أفهم.
-“ما كنت مفكرتا هيك”.. قالت وزادت من استغرابي..
-“كيف يعني هيك؟” سألت..
-يعني.. (ولفّت ساقاً على ساق، ثم نظرت الى أبي الذي لا يزال يمعن النظر في جهاز الراديو والمذيع لا يزال يعرض أخباره)- عايشة لوحدا.. فهمنا، قوية وقديرة وقد حالا.. كمان فهمنا بس بتستقبل ببيتا شباب كمان؟ لا هيك كتير”.
ما بها أمي؟ أي حكم أصدرته بحق سالي؟ أنَس وفوزي ليسا أي شابين، ثم أنهما أتيا الى بيت سالي لأجلي.. لا يمكن أن أفضح القصة، لكن سأدافع عن سالي.. قلت:
-ماما سالي كتير طيبة حبّت تجمع كل رفقاتنا بمناسبة نجاحي..
-رفقاتنا؟ رفعت أمي حاجبيها وهي تنظر مباشرة الى عيني، ثم حوّلت نظرها عني وحركت شفتيها بسخرية جارحة:
-“بشششش!! ليه هيدا المصري واللي معو؟ رفقاتكن.. مين انتو يعني؟ انتي”؟
“هيدا المصري”؟ غرف قلبي.. إلا أنني لم أصدر صوتاً.. أنَس ابن العائلة العريقة الذوّاق الوسيم المثقف المؤدب.. أنَس حبيبي.. أصبح في حكم أمي “هيدا”؟
لم أستطع أن أردّ.. بأي منطق أجيب؟ ماذا أقول لها؟ في الأساس.. هي لم تسأل كي أجيب.. بل هي تبلغني..
-“عملي معروف ماما- قالت بلطف مصطنع- سالي ما بتناسبنا ولا الشباب اللي عندا مزبوط يا ألبير”؟
على الفور، خرج أبي من عالم الأخبار الذي كان غارقاً فيه، واضحٌ أنهما متفقان:
-“شوفي بابا.. انتي هلق صبية وبتفهمي.. بنت بتستقبل شباب عندا بالبيت ما بتناسبنا.. كلامي واضح ما بقا فيه الك أي تعاطي معا”.
هكذا إذن، اتفقا عليّ كل الليل.. هذا سرّ كل تلك الهمهمات..
لم تعد سالي تُعجب والديّ.. لأنها استقبلت أنَس وفوزي في بيتها.. لن يصدقا أن نيتها كانت صافية، أن تجمع أهلي بأَنَس، لكنها تعجبني وهي صديقتي وراعية حبي لأنس.. كم ظلما سالي وظلماني.. سالي متحرّرة من دون شك.. لكنها حرية بنوايا صافية.. وكان عليّ أن أدّعي أنني وافقتهما، كي أستوعب ما جرى وكي لا أُحرم من اللقاء بأنَس؟ وكان عليّ أن أكذب.. لا خيار آخر أمامي..
كذبت على أمي حين قلت لها إنني سأذهب إلى الجامعة لأسأل عن كتب السنة الثانية وأبدّل كتب السنة الماضية.. كنت اتفقت مع أنَس أن نلتقي بعد اسبوع في كافيتريا الجامعة، ليودعني قبل سفره في إجازة الصيف إلى مصر.
لم أهتم كثيراً إن كانت أمي صدّقتني أم لا.. ربما تركت لي هامشاً لأنفذ ما طلبته هي وأبي من قطع علاقتي بسالي.. لا أعرف ولا أريد أن أعرف.
من قال إن بعض الحب لا يعلّم التحايل والمعاندة؟
والتقيتُ بأنس.. استقبلني مشتاقاً بتقبيل يديّ.. يا لهذا الشعور بالدفء ودغدغة القلب، ينسي كل قلق الأيام الماضية.
بقيَ ممسكاً بيديّ طول الوقت، لم أشأ أن يتركهما وهو أيضاً..
أخبرني كم أحب عائلتي، كم يكن كلّ الاحترام لأبي المثقف والمربي الفاضل، ووالدتي “اللايدي” قال إنهما سيتفقان مع أهله كثيراً.. سيصبحون معاً أعزّ الاصحاب حين نتزوج.. وانه سيكون لهما جناح خاص في بيتنا الكبير، حين نستقر أنا وهو في مصر..
ووعدني أنه فور وصوله الى مصر، سيفاتح أهله بطلب يدي.. سيرتب معهما كل شيء، فترة خطوبة لا تتعدى السنة.. ثم زفافنا الكبير.
ودّعني أنَس بأن ضمني إلى صدره مع سبق الاشتياق.. وطبع قبلته الأولى على خدي.. ثم تسلّل إلى شفتيّ.. فملّكني الكون.
لم أخبره ما جرى.. حزني لسفره يساوي ما قرّره والداي وما قالته أمي.
أوصلني أنَس إلى مفرق البيت، لم أصدق أنه سيكون بعيداً عني شهور الصيف..
ياه.. كم بكيت ليلتها.. بكيت كثيراً لم تسألني أمي عن السبب ولا أبي.. ظنّا أنني قطعت فعلياً علاقتي بسالي.
..يتبع